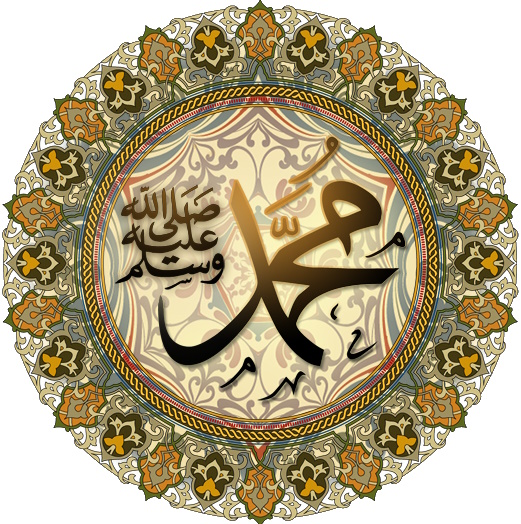


عطية مرجان ابوزر
ولا ريب أن شهوة النكاح من طبيعة الإنسان فكمالها فيه من كمال طبيعته، وقوتها فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة، ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نتحدث أنه ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أعطي قوة ثلاثين). يعني على النساء، وهذا والله أعلم، ليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن بلا حصر ولا مهر، ولا ولي، فيقوم بحقوقهن، ويحصل بكثرتهن ما حصل من المصالح العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جميعًا، ولولا هذه القوة التي أمده الله بها ما كان يدرك أن يتزوج بكل هذا العدد، أو يقوم بحقهن من الإحصان والعشرة.
ولو فرض أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة والتمشي مع ما تفتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في مقام النبوة، ولا نقص في حقه، صلى الله عليه وسلم ( كمثل من سبقه من الأنبياء) كيف وقد قال، صلى الله عليه وسلم : ((تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين)).
وقد قال الله له : {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنّ} [الأحزاب: 52]. لكننا لا نعلم حتى الآن أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، تزوج امرأة لمجرد قضاء الوطر من الشهوة، ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جمالاً، الشابات سنًّا، كما قال لجابر – رضي الله عنه - حين أخبره أنه تزوج ثيبًا، قال: ((فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟)) وإنما كان زواجه، صلى الله عليه وسلم : إما تأليفًا، أو تشريفًا، أو جبرًا أو مكافأة، أو غير ذلك من المقاصد العظيمة.
ما ثبت في الحكمة في استكثاره من النساء كان منه ما يلي :
- نفي ظنون المشركين فيه من أنه ساحر أو غير ذلك.
- كثرة دخول قبائل في الإسلام حيث كانت تتشرف قبائل العرب بمصاهرته.
- الزيادة في تألف القبائل المتصاهر لذلك.
- الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ.
- لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه.
- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله.
- الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة. فقد تزوج أم حبيبة وأبوها يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن.
- بيان خرق العادة(معجزة) له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب، وكثرة الصيام.
- أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه،
- (معجزة) صلى الله عليه وسلم. وهو إظهار كمال عدله في معاملتهم لتتأسى به الأمة في ذلك.
- كثرة انتشار الشريعة فإن انتشارها من عدد أكثر من انتشارها من واحدة.
- جبر قلب من فات شرفها كما في صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق.
- تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي رسخت في قلوب الناس من منع التزوج بزوجة ابن التبني، كما في قصة زينب فإن اقتناع الناس بالفعل أبلغ من اقتناعهم بالقول، وانظر اقتناع الناس بحلق النبي، صلى الله عليه وسلم ، رأسه في الحديبية ومبادرتهم بذلك حين حلق بعد أن تباطئوا في الحلق مع أمره لهم به.
- التأليف وتقوية الصلة كما في أمر عائشة وحفصة، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم ، شد صلته بخلفائه الأربعة عن طريق المصاهرة، مع ما لبعضهم من القرابة الخاصة، فتزوج ابنتي أبي بكر وعمر، وزوج بناته الثلاث بعثمان وعلي –رضي الله عن الجميع- فسبحان من وهب نبيه، صلى الله عليه وسلم ، هذه الحكم، وأمده بما يحققها قدرًا وشرعًا، فأعطاه قوة الثلاثين رجلاً، وأحل له ما شاء من النساء، يرجي من يشاء منهن، ويؤوي إليه من يشاء، وهو سبحانه الحكيم العليم.
.jpg)
وأما ابنة الجون فلم يعدل عن تزوجها بل دخل عليها وخلا بها ولكنها استعاذت بالله منه، فتركها النبي، صلى الله عليه وسلم ، وقال: ((لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك)). ولكن هل تزوجها النبي، صلى الله عليه وسلم ، لمجرد جمالها وقضاء وطر النكاح أو لأمر آخر؟ إن كان لأمر آخر سقط الاستدلال به على أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يتزوج لمجرد قضاء الوطر، وإن كان لأجل قضاء الوطر فإن من حكمة الله – تعالى - أن حال بينه وبين هذه المرأة بسبب استعاذتها منه.
وأما سودة – رضي الله عنها- فقد خافت أن يطلقها النبي، صلى الله عليه وسلم ، لكبر سنها فوهبت يومها لعائشة، وخوفها منه لا يلزم من أن يكون قد هّم به. وأما ما روي أنه طلقها بالفعل فضعيف لإرساله.
وأما زواجه، صلى الله عليه وسلم ، بزينب فليس لجمالها بل هو لإزالة عقيدة سائدة بين العرب، وهي امتناع الرجل من تزوج مفارقة من تبناه، فأبطل الله التبني وأبطل الأحكام المترتبة عليه عند العرب، ولما كانت تلك العقيدة السائدة راسخة في نفوس العرب كان تأثير القول في اقتلاعها بطيئًا، وتأثير الفعل فيـها أسـرع فقيض الله – سبحانه - بحكمته البالغة أن يقع ذلك من النبي، صلى الله عليه وسلم ، في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي، ولا يكون في قلوبهم حرج منه، وقد أشار الله – تعالى - إلى هذا الحكمة بقوله – تعالى -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [الأحزاب: 37].
ثم تأمل قوله – تعالى -: {زَوَّجْنَاكَهَا}. فإنه يشعر بأن تزويجها إياه لم يكن عن طلب منه، أو تشوف إليه، وإنما هو قضاء من الله لتقرير الحكم الشرعي وترسيخه، وعدم الحرج منه.
وبهذا يعرف بطلان ما يروى أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أتى زيدًا ذات يوم لحاجة فرأى زينب فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال: ((سبحان الله مقلب القلوب)). فأخبرت زينب زيدًا بذلك ففطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي، صلى الله عليه وسلم ، وقوله: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } [الأحزاب: 37].
فهذا الأثر باطل مناقض لما ذكر الله – تعالى - من الحكمة في تزويجها إياه، وقد أعرض عنه ابن كثير – رحمه الله - فلم يذكره، وقال: أحببنا أن نضرب عنها ـ أي عن الآثار الواردة عن بعض السلف ـ صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها، ويدل على بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء فضلاً عن أفضلهم وأتقاهم لله – عز وجل -، وما أشبه هذه القصة بتلفيق قصة داود عليه الصلاة والسلام، وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا زوجة واحدة، على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله – تعالى -: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ} [ص: 21]. إلى آخر القصة فإن من علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم والعدوان والمكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام.


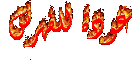
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق